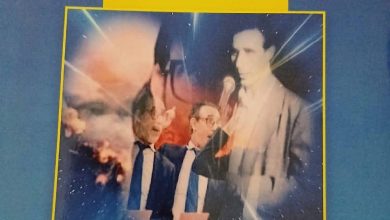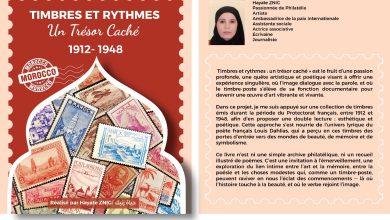“حكايات مستدركة بهوامش الحلم” للقاص الراحل محمد المهدي السقا، قصص تعتمر طاقية الإخفاء

صخر المهيف طنجة.
إذا كنت سأجازف بالقول أن الكاتب الراحل محمد المهدي السقال من الكتاب المغاربة المنتسبين الى جيل الثمانينات من القرن الماضي الذين شكلوا امتدادا للقصة المغربية منذ بواكيرها الأولى التي يختلف الباحثون الاكاديميون المغاربة حول تحقيبها، فإنه يجب عليّ التنويه أن مجموعته القصصية البكر “حكايات مستدركة بهوامش الحلم” مسكونة بهواجس المرحلة واسئلتها الحارقة، واستدعائها أحداثا تاريخية فاصلة من التاريخ المغربي المعاصر مجسدة في انتفاضتي 23 مارس 1965 و 20 يناير 1984 وما كان لها من نتائج وتداعيات على المشهد السياسي المغربي لاحقا.
صدرت المجموعة القصصية “حكايات مستدركه بهوامش الحلم” عن دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر بالرباط سنة 2014 في 75 صفحة من القطع المتوسط موزعة على أربعة وأربعين نصا قصصيا، وقد صممت غلافها هند السعدي.
إن أول ما يستوقف المتلقي هو نأي القاص عن تجنيس عمله السردي حيث اكتفى بنعت مجموعته بنصوص سردية، على أنه يمكن للمتلقي أن يصنف نصوص المجموعة القصصية إلى نصوص قصصيه قصيره وأخرى قصيره جدا، ومن المميزات التي وقفت عليها إبان تصفح هذا المتن القصصي:

-توسل الكاتب الراحل محمد المهدي السقال بالتناص التراثي في قصته “البكر” ولم يكن هذا التوسل سوى حيلة لنقد فساد السلطة السياسية واستبدادها، يقول السارد: “لم تكن تعرف سوى أنهم اذا دخلوا قريه افسدوها” ص30، وفي قصته المأساة الإلهية يتجلى هذا التناص التراثي بكل وضوح، وليس خافيا أن عنوان هذه القصة يتناص مع كوميديا دانتي التي تتناص بدورها في بعض أجوائها مع رسالة الغفران للمعرّي، ففي هذا المتن يتخيل القاص الحشر في يوم النشور و ذلك في دلالة لافتة إلى عبث الوجود ولامعناه في غياب مفهوم واضح للإرادة والفعل الإنسانيين، وفي هذا المقام يستثمر القاص اللغة التراثية بشكل لافت إذ يقول السارد: “هي ذي جهنم التي كنتم إليها منتهون”.
وفي قصة “حماري والأمير” يستحضر القاص حكاية جحا وحماره التراثية ليقوم بعملية إسقاط لهذه الحكاية الشعبية على الواقع المعاصر الذي يتسم أفراده بالسلبية وغياب ظهور أي إرادة جماعية للتغيير والتمرد، يقول السارد:”عضضت على الخبز بالنواجد مطمئنا على أدنى انشغال بالممكن من حماري” ص 39، ويعرج القاص محمد المهدي السقال على قسم آخر من أقسام التراث، وهو التراث الفقهي الإسلامي في شقه السياسي حين يستدعي فقه مالك ابن أنس السياسيّ ويجعل منه خلفية لتصريف موقفه من السلطتين الدينية والسياسية وهما المتحالفتان دائما على امتداد التاريخ الإسلامي، يقول السارد: ” قال الغزالي: وهذه بدعة لا يجوز القول بها” ص 35، ولم يفت القاص أن يستزيد من التراث الجاهلي في شخص أحد فطاحلة شعرائها عبيد بن الأبرص شاعر بني أسد وفارسها الذي شارك في التمرد على الملك حجر بن الحارث الكندي والد امرؤ القيس والتخلص منه بالقتل في قصة “الذبابة و الملك”، لقد قام الكاتب بتركيب سيرة عبيد و حكاية الملك و الذبابة، ص 10.
-مارس الكاتب نقدا مزدوجا للسلطة والمجتمع في تماه واضح مع مفهوم الالتزام السارتي حيث كتب للآخرين ما فكر فيه فعلا، ففي قصّة النفق يقول السارد: “كيف أموت قبل التوصل بما تدلي به هذه العاصمة اللعينة” ص 22، بعد أن اشتكى الموظف المتقاعد من تأخر صرف مستحقاته حولين كاملين ما يعبر عن موقف سلبي من السلطة وربيبتها البيروقراطية من قبل السارد، هذا الموقف لا يجد تبريره إلا في “تساؤله العريض وراء سر اختفاء مرافقه قبيل خروج القطار، قطار الحياة من النفق .
و يبلغ نقد السلطة أقصى مداه في قصة “الوصية المعلقة”، فالسارد يعتقد أن صاحب السلطة لا خير يأتي من ورائه ولم يشفع له السارد إلا بعد تخليه عن مظاهرها: “قال أبي متنهدًا على الذي لعله أراد أن يموت رجلاً ” ص31، وقد استمر نقد السُّلطة في قصتي “الثلث الناجي” و”خلف الصمت ” وفي قصته “عبور الموكب الرسمي” و “سورة الكافرون”، من جهة أخرى، تضمنت المجموعة نقد المعادل الموضوعي للسلطة، أي مقابلها المادي المتمثل في أفراد الشعب بكل فئاته، فالمناضل الذي واجه العسف والظلم من أجل الشعب، تعرض إلى تهميش قاسٍ من طرف الذين ناضل من أجلهم، ذلك أن الهاشمي الضرير الذي اشتكى من مرض و من تعب لم تصالحه الأم، فإذا به رمز لذاكرة جمعية مخدوشة، وكأني بالكاتب الراحل قد أصغى لعبد الرحمن منيف و هو يهمس بصوت جريح: “مأساة الإنسان الحقيقية تكمن في أن أقرب الناس إليه هم أول خصومه”.
إن النقد من حيث هو عملية عقلية تعتمد استراتيجية الهدم و البناء ، هدم القائم الموجود وبناء المنشود، وتتطلب هذه العملية حدا معقولا من الموضوعية، لهذا لم يكتف القاص محمد المهدي السقال بنقد السلط الدينية والاجتماعية والسياسية فقط، بل تعداه إلى نقد المجتمع وكـل مظاهر فساده و نكوصه، ففي قصة “حماري و الأمير” المومإِ إليها سالفاً، لا تحرك الجماهير ساكنا على الرغم من استئثار صاحب السلطة بالخيرات دونها على مرأى من بصرها ، وتعكس قصة “حرجٌ متأخر” خيبة أمل السارد من السياسة و الرفاق، رفاق الدرب السياسي، فالخيمة التي عقد فيها الاجتماع تحيل على الماضي و القبيلة وحياة الترحال في تضادّ سوريالي مع الحاضر الذي تخترقه القيم التقليدية و الممارسات السياسية العتيقة القائمة على تمجيد الزعيم القائد وعبادته، و هو ما يختصه السارد في الصفحة 40 : “أشفقت على رحلة الرفقة السعيدة، من حرج ربما يشعرون به من وجود أمثاله في حيطانهم ينتظرون نفس المصير”. و لعل هذا ما جعل الكاتب يطرح سؤال الكتابة في صياغة فنية بشكل ملح في قصة “البراز المشتهى” في محاولة منه لإدراك مفارقات المجتمع فنيا من خلال الرصد المحايد لظواهر اجتماعية سلبية في إطار نقد مزدوج مارس نفسه داخل الذات (المجتمع) و على الآخر (السلطة) و داخل الآخر (السلطة دائما) متساوقا في ذلك مع المفكر المغربي الراحل عبد الكبير الخطيبي في سعيه إلى نقد مفهوم الهويّة الذي انبنى عليه الفكر العربي النهضوي الكلاسيكي و تطوراته اللاحقة بعد انفتاحه على الليبرالية والماركسية والقومية العربية، حين وضع الهوية العربية في مأزق على حد قول الكاتب المغربيّ فريد الزاهي.
و في السياق ذاته ينتقد محمد المهدي السقال طبيعة التشكيلات السياسية اليسارية التي ترفض ممارسة نقد ممارستها السياسية على أعضائها، بالمقابل تفرض انضباطا تنظيميا و إيديولوجيا صارما يجرد المناضل من إمكانية المساءلة و عرض الطرح المضاد، فزعيم التنظيم ينتقد جرأة المناضل المنفي قائلا:”نحن ننتقد الحكومة وأنت مصر على نقد الحكم، لم تدرك بعد حجم التغيّر في العالم” “قصة أربع نساء” ص 50 من المجموعة.
يعتمر محمد المهدي السقال طاقية الإخفاء في لعبته السردية داخل عدد من نصوص المجموعة، فتراه يطعن في السلطة السياسية الفاسدة بسهام النقد و يعتبرها بلا شرف، حين يصور الزعيم السياسي رجلا لا ذمة له ولا عهد باعتباره خائنا مزدوجا للعائلة و للخط الإيديولوجي للحزب الذي ينتمي إليه، لهذا تواطأ بشكل غير معلن مع زوجته على الخيانة في تعارض واضح مع القيم المجتمعية، وكأنه ينتقم من السلطة السياسية عبر كشف عورتها الخبيثة مجسدا انتقاما لاشعوريا من الطبقة السياسية عبر فعل الكشف، يقول السارد في قصة امرأة من زجاج ص 26 : “تذكره ابتسامته الماكرة في وجهه كل صباح بعجزه عن الانتقام لشرفه، كلما فاتحها في التخلص من هذا العبد الأجلف”.
يعتمر الكاتب طاقية الإخفاء مرة ثانية وكأنه يذكرنا بشخخصية أبي الخيزران في رواية “رجال في الشمس” للراحل غسان كنفاني الذي يرمز للقائد العاجز عن قيادة شعبه نحو الخلاص وهو العاجز جنسيا ! فالسياسي العجوز/ العاجز جنسيا لم يتم انتخابه إلا بعد التزوير في قصة “افتضاح”، وقد اختار السارد أن يبين لنا كيف تراجعت الزوجة ممسكة بظفيرتيها المسدلتين حتى النهدين، وكيف قرأت في عينيه خجلا من توالي الليالي البيضاء (وليس الحمراء) منذ عام، لقد صور الكاتب عجز السياسي الفاسد عجزا جنسيا و بيولوجيا ( التجاعيد – طقم الأسنان ) وعجزا عن حل مشاكل الناس، وليس ذلك إلا نتيجة للالتفاف على الفعل الديموقراطي عن طريق عملية تزوير النتائج، فتحضر هنا أزمة موضوع السلطة ومن ثم جاء النقد ليكشف عمق الأزمة، أزمة (السلطة السياسية) في إدراك واع من القاص لماهية الكتابة وحدودها وأدوارها.
-لقد وقفت في نصوص هذه المجموعة القصصية على ميزة أخرى تتمثل في الحضور اللافت للميتاقصة، أملته رغبة دفينة في ممارسة لعبة سردية لا تستهوي إلا قلة من الكتاب المغاربة، و لعل هذا مؤشر دال على فورة الذات الكاتبة في الممارسة الإبداعية و سطوعها و محاولة تأثيرها في عملية التلقي، ذلك أنه “عندما تصبح الكتابة ممكنة فهي تتقلد خاصيات ضرورية القراءة فتصبح الكتابة عندها حميمية القارئ” حسب تعبير موريس بلانشو.
في قصة “حكاية رجل كالطود ” يتساءل السارد: “أين توقفنا أمس؟” وفي النهاية وقعت على محضر بخط اليد، أمتنع بموجبه عن تدوين قصتي “من الاعتقال إلى المنفى”، وجعل القاص القصة تتحدث عن ذاتها و تنشغل بتركيب بنيتها الفنية وآفاقها الدلالية، وحضر سؤال الكتابة بقوة في قصة “المأساة الإلهية” بإبراز الانشغالات والهواجس الشعورية واللاشعورية للذات الكاتبة حين يقول في القصة ذاتها : “سأعود لهذه الرؤيا كي أنقحها و أنسج منها قصة قصيرة جدا”، وهذا يجبرنا على طرح جملة من الأسئلة على اختيارات الكاتب الفنية والجمالية، فلماذا هذا الإصرار على كسر الجدار الرابع مع المتلقي بالعسف قليلا على برتولد بريخت؟ لماذا التوسل بهذا النمط الفني في الكتابة القصصية التي تسعى إلى تقليص صلاحيات السارد العالِم بكل شيء؟ ألأن العبارة ضاقت باتساع المعنى في بعده الوجودي الدّال على التحقق؟.
-و الحصيلة أن محمد المهدي السقال كان منسجما في نصوص هذه المجموعة مع قناعاته الفكرية، و قد وقفت على تمظهرات فنتستيكية مرتبطة بالواقع ذاته، كما أن معظم النصوص التي مارس فيها نقدا مزدوجا صيغت في ثوب الميتاقصة متساوقةً مع عنف اللحظة التاريخية وضراوتها.