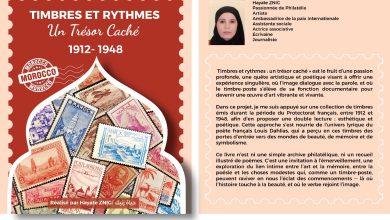فصل المقال فيما بين الدين والسياسة من الاتصال

د. المصطفى الشادلي.
في زخم الأحداث تمر الذكريات والمناسبات في صمت.لا نكاد نلتفت الى أهميتها لأننا مشغولون عنها وعن أنفسنا بمحاولتنا الدؤوبة والفاشلة في غالب الأحيان تنظيم عالمنا المبعثر والبحث عن أجوبة لأسئلة تؤرقنا باستمرار، ناهيكم عن صراعنا الدائم مع الأوهام التي فرضتها علينا المعاصرة باعتبارها لوازم ضرورية لحياتنا، بل باعتبارها ضروريات حياتنا.
هذا من جهة . من جهة أخرى ان العادة هي العدو الأول لطرح السؤال. نتعود على الأشياء والظواهر والأحداث فنقبلها في نهاية المطاف كما هي لا كما ينبغي ان تكون. هي نوع من العمى الفكري الذي يحجب عنا حقائق الأشياء ويحول بيننا وبين “طرح السؤال” .
فمن منا حاول ان يتسلل من وطأة الأحداث واليومي ويتساءل عن حقيقة الشمس مثلا…ومن منا رفع بصره الى سقف بيته والتفت إلى بعض الشقوق أو الى أعشاش العناكب التي بدأت تتشكل في موقع ما من أركان بيته في غفلة من وعيه وبصيرته؟
وقس على ذلك بالنسبة إلى الكثير من القضايا التي تهم حياتنا الخاصة والمعاصرة عموما.
كل ذلك وغيره صرفنا عن طرح السؤال بخصوص العديد من قضايانا الثقافية والسياسية والاجتماعية والدينية
في هذا السياق نريد ان نخلخل عصابة “العادة” و نختلس رؤية ،من زاوية جديدة، إلى طقس ديني اومناسبة او ذكرى دينية لها مكانة خاصة في قلوب العرب والمسلمين عامة
ونتساءل: ما موقعنا مثلا من مناسبة “عيد المولد النبوي”؟
ليست المناسبات الدينية إحياء لسنة او بعثا لذكرى او تجديدا لشعيرة، وليست طقسا روتينيا، يمر فينسى، وما أكثر مناسباتنا وأعيادنا الدينية وطقوسنا التي لم نحيها فقط بل قتلناها بصلواتنا واحتفالاتنا ودعواتنا ومرت ثم بقينا نراوح مكاننا في الزمن، ننتظر سنة أخرى ومناسبة قادمة لنعيد ممارساتنا الميكانيكية وصخبنا.. ويدور الزمن دورته ويجدنا في نفس الموقع لم نتقدم قيد أنملة، لم ناخذ عبرة، لم نثر على واقع ، ولم نتغير إلى الأحسن!
هذه حالة عالمنا العربي والإسلامي عموما. لذلك يستغرب البعض كيف ان أمة باتت تصلي وتصوم وتحج مجتمعاتها إلى بيت الله افواجا، لا تزال تثير شفقة الآخرين في الضفة الأخرى، المقيمين على شط التقدم.! وكيف أن امة لا تزال تعمر مساجد الله، ومساجدها تعد أكثر من مدارسها وجامعاتها ومن مستوصفاتها، لا تزال تتسول على أعتاب الغرب القمح والدواء وغيرهما من متطلبات البقاء.!.وكيف أن امة اقرأ التي رفعت شعار القراء للجميع منذ فجر الاسلام هي التي تعج بجيوش الأميين على اختلاف درجاتهم ونسبهم؟..
ومن هنا تثور ثائرة الحداثيين ويعلنون الكفر بالتراث والقيم الدينية والإسلامية وبعادات مجتمعاتنا العربية…
لكن الأمور ليست على هذه الدرجة من السطحية والتبسيط.
إن التراث سلطة. دم يسري في عروقنا، ومكونات تمتزج بجيناتنا . فهو بلغته وثقافته وعقائده وطقوسه..كل ما يكون هويتنا العربية والاسلامية او ما يشكل “الأنا “المقابلة ل ” الآخر “اي الغرب وثقافته. لذلك يستحيل التخلص منه والتحرر من سلطته. ونعتقد أنه حتى عتاة الحداثيين الذين يرفعون شعار التغريب والحداثة على مستوى اللغة والحياة، لا يستطيعون إنكار نداء التراث الذي يتردد في اعماقهم ولا يستطيعون إنكار ميلهم الفطري إلى مناخهم الثقافي الذي يحد بحدود اوطانهم. ولا يستطيعون ان يتجاهلوا إحساسهم الغريب لدى سماعها إيقاعا موسيقيا تراثيا.. وهل يقبلون بأن تمس أوطانهم بسوء حتى وهم خارج أوطانهم الاصلية يعيشون في رحاب الآخر او الغربة؟.
واذن فالأمر لا يتعلق بمسألة التحرر مما سماه محمد عابد الجابري ب “سلطة التراث” وإنما يتعلق بمسألة التراث الذي نريده.
ومن هنا فإن السؤال الذي يجب ان يطرح بوضوح هو: ما موقفنا من التراث؟. انعتبره مجرد ممارسات واحتفالات ظرفية، نمارسها بنوع من التكرار الممل كل سنة؟.
انعتبرة مجموعة من العقائد المقدسة التي لا تقبل الحلحلة والنقاش ومجموعة من المعارف والأفكار التي لا تقبل الجدل بقدر ما تقبل الاجترار؟
انعتبره سلوكيات وعادات تمارس بغباء بعيدا عن الوعي بقيمتها وقدرتها على منحنا طاقة متجددة في حياتنا المعاصرة؟
والجدير بالذكر ان كل الأمم بما فيها الأمم المتقدمة على صعيد العلم والتقنية والحداثة عموما تحتفظ لتراثاتها بمكانة مقدسة في فضاء حياتها. لذلك لا نستغرب حين نراها تصر على إحيائه بطرقها الخاصة، والاحتفال بمناسباته ولا سيما مناسبات أعياد الميلاد، إيمانا منها بأن تقدمها التقني لا يكتمل إلا بتقدمها التراثي والحضاري.
وعلى هذا الأساس فالمناسبات الدينية وغير الدينية المتعلقة بالتراث والماضي عموما هي فرصة لتأكيد الهوية الوطنية والحضارية، وفرصة لتأكيد فرادة “الذات”الحضارية عموما.
ومن ثمة لا عجب إذا رأينا بعض الدول المصطنعة ، التي لا ماضي ولا تاريخ ولا ثقافة لها تكرس كل طاقاتها، وإمكانياتها المادية والإعلامية لخلق النموذج الثقافي والتراثي والحضاري المفقود ، وبالتالي اصطناعه وعبادته. لأنها تدرك في قراراة نفسها بأن من لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل له.
(وهذه حال إسرائيل مثلا)، إيمانا منها بأن القوة العسكرية والسلطة الإعلامية غير قادرتين لوحدهما على حماية الوجود وتحصين الذات من الاندثار.
مناسبة هذا الكلام حلول ذكرى مولد النبي (ص) وهذه الذكرى جزء من بنية ثقافية عربية وإسلامية يحق للإنسان العربي ان يفتخر بالانتماء إليها. فنماذجها الإنسانية سواء كانت في شكل شخوص دينية كالنبي محمد او تاريخية وسياسية كعمر بن الخطاب وعنترة وصلاح الدين الايوبي..إلخ أو كانت في شكل طقوس وسلوكيات..لا تزال مشعة بالنور الثقافي والأخلاقي والقيمي والحضاري بشكل عام.
ونعتقد ان المفكرين والسلوكييين والأخلاقيين، المتعاقبين على منبر الحضارة الإنسانية، لم يضيفوا شيئا جديدا الى هذا الصرح القيمي الذي بنته شخصية محمد (ص).
والسؤال الذي يجب ان نطرحه بالمناسبة هو : ما هي العبر التي يمكن استخلاصها منها؟.
هي أكثر بكثير مما يمكن ان يسرده مقال بسيط في مقام ضيق بدون شك. ولقد فصل الكثير من المفكرين والدارسين العرب والمستشرقين المنصفين مزاياها المتعددة، وافردوا لها كتبا مستقلة.
لكن يجدر بنا ان نركز على قيمة سلوكية عظيمة ما أحوجنا الى استحضارها في هذا الظرف بالذات ، الذي كثر فيه الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتناسلت خلاله الاحتجاجات على بعض السلوكيات التي تخص رجالات السياسة المحسوبين على “الدين”.
وفي هذا المضمار تثار بطبيعة الحال إشكالية علاقة “الدين”ب”السياسة”،او علاقة “المال”ب”الاخلاق”.
ترى ما علاقة الدين بالسياسة؟
قديما طرح المفكرون والفلاسفة العرب سؤالا كبيرا مماثلا ، لكنه يتعلق بعلاقة (الحكمة)ب (الشريعة) وثار جدل بين الفرقاء التراثيين والحداثيين في رحاب الماضي..مما حدا بالفيلسوف ابن رشد الى تأليف كتابه الشهير “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”واستقر رايه في نهاية المطاف حول خلاصة مفادها أن لا تعارض بين الدين والفلسفة ما دام كل منهما وسيلة تساعد العقل البشري على بلوغ الحقيقة . ومن ثمة خلق نوعا من التصالح بينهما باعتبار الواحدة أخت الأخرى من الرضاعة! ضدا على ما يذهب إليه الفقهاء المتزمتون، أعداء الحكمة والفلسفة.(وهذا موضوع اخر لا بهمنا في هذا المقام).
لكن ما يجب الإشارة اليه، والشيء بالشيء يذكر كما يقال، هو أن عصر ابن رشد انشغل بالقضايا الثقافية أكثر من انشغاله بالقضايا السياسية. فلم يكن في عصر ابن رشد. مثقفون كان همهم هو المزاوجة بين ” الدين” و”السياسة”! فلم تكن ظاهرة توظيف الدين في مجال السياسة او موضة توظيف السياسة في مجال الدين معروفة وممارسة…ولو كان الامر كذلك لسارع ابن رشد إلى تأليف كتاب بعنوان(فصل المقال فيما بين السياسة والدين من الاتصال)!
لكن هل هذا يعني أن مجتمع ابن رشد وغيره من مجتمعات العصور القديمة، سواء بالمغرب والأندلس او بالشرق ، لم يكن يعرف ظاهرة التداخل بين الدين والسياسة؟. كلا. في كل الأزمنة والأمكنة ومنذ ان تأسست الدولة العصرية في أثينا، أنتبه الفلاسفة والمفكرون الى حقيقة لا تزال معضلة كل العصور ، ألا وهي أن الاستبداد هو الوجه الآخر للسياسة. بعبارة أخرى لا سياسة بدون مكر ودهاء ونفاق وقوة تحمي القرار السياسي . وهذه الخصال موجودة في كل المجتمعات البشرية ويتبناها ممارسو السياسة بدءا من أصغر مكونات الهرم السياسيي في القاعدة الى اعلى سلطة في رأس الهرم.
لكن اذا كان الدهاء السياسي والقوة شرطا، مطلوب توفره في شخصية السياسي، هل المال ضروري ؟.بعبارة أخرى هل على السياسي أن يكون بورجوازيا واقطاعيا ومالك عقارات ورجل أعمال ثريا لكي يتمكن من ممارسة السياسة؟. وهل السياسة هي أخت المال وشقيقته؟ إلا يمكن للسياسة أن تمارس لذاتها بعيدا عن المال ، من أجل قيم أخرى غير الثراء؟
للإجابة عن هذا النوع من الأسئلة يجدر بنا استحضار شخصية النبي محمد(ص). فمن المعلوم أنه لم يكن رجل دين فقط وإنما كان أيضا رجل سياسة (راجع بهذا الخصوص كتاب”الفكر السياسي الاسلامي” للمستشرق البريطاني مونتغمري وات). لقد كان محمد(ص) رجل سياسة، بمعنى أنه أرسى دعائم دولة سياسية الى جانب ترسيخه دعائم الدين الاسلامي في مجتمع أهم ما يميزه أنه مجتمع طبقي، انطوى على صراعات بين قوى المال اي البورجوازية المكية وبين المستضعفين ( او البروليتاريا بلغة العصر والماركسية).(وهذا موضوع آخر ممكن التوسع فيه بمراجعة كتاب “مشروع رؤية جدية للفكر العربي في العصر الوسيط ل “الطيب التيزني” مثلا).
لكن ما يهمنا هو أن الرسول ص وجد نفسه في المعترك السياسي. وكان عليه أن يمارس السياسة سواء بالعلاقة مع دول الجوار والامبراطوريتين القديمتين الفارسية والبيزنطية والممالك الأخرى او مع القوي السياسية التي تحصنت بسلطة المال وجعلت منها ترسها لمقاومة التغيير الذي من أجله جاءت الدعوة الإسلامية.
والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو : هل كان النبي سياسيا ماديا ؟. بمعنى هل وظف السياسة من اجل المال والثراء والامتلاك.؟وهل كان همه هو احتلال مركز القوة المادية الذي كانت تملكه البورجوازية المكية؟ .
وهل كانت السياسة بالنسبة إليه وسيلة إلى تكديس الثروات و”المعاشات”؟وهل كان يطالب عشيرته برفع أجره من أجل التمكن من مواصلة بسط مشروعه الديني والسياسي؟.
وهل كان المال حينذاك حصانا ضروريا لجر عربة “الدين والسياسة”؟. وهل كانت علاقة حصان المال بعربة الدين والسياسة وسيلة ضرورة لبلوغ هدف مادي ما، كخلق الثروات أو بناء القصور و امتلاك اصطبلات الخيول المسومة و القانطر المقنطرة من الذهب والفضة.. وقطعان الابل وغيرها من ملامح الثراء في الماضي؟؟
كان بإمكانه(ص) ان يحقق كل هذه المكاسب المادية ويبلغ كل الأهداف النفعية المادية بأقل تكلفة دون أن يكلف نفسه عناء التصدي للقوى البورجوازية المعاصرة له المتكسبة من الآلهة وتعدد الاوثان،.. وكان بإمكانه أن يتخلى عن مشروع الوحدانية او التوحيد إرضاء للبورجوازية المكية وان يساوم مبادئه السامية باغراءاتها وهداياها السخية المعروضة عليه..لكنه أبى!فقال قولته الشهيرة ردا على عرض عمه أبي طالب بهذا الخصوص : ( يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الأمر حتى يظهره الله او اهلك فيه ما تركته)..
ما أروع هذا الكلام!. وما معناه بالنسبة الينا نحن المعاصرين؟
لأول مرة في تاريخ الإنسانية تعرض السياسة كل اموال الدنيا على رجل سياسى فيتحصن بالعفاف و الإباء وينتصر للقيم السامية التي يؤمن بها.
ولأول مرة في التاريخ السياسي نجد رجلا سياسيا ينتصر للأخلاق، ويميل إلى المثل العليا بدل الميل إلى السلطة المادية وما ترمز إليه من اغتناء فاحش وتبرجز!.
والحق ان سيرته(ص) تؤكد لنا نبل هذه الشخصية وطهارتها. فهل ترك لنا آثار ا مادية ما ،سكنا فارها وعقارات؟ مثلاا..وهل خلف وراءه اثاثا فخما ..والبسة فاخرة من حرير ..وأوان من ذهب وفضة..وغيرها مما يمكن العثور عليه في متحف عربي او اسلامي، ومما يمكن أن يشير إلى نمط حياة وأسلوب عيش متسم بالترف ؟.
كلا. ترك لنا كتابا كريما وسيرة نظيفة وقيما سامية وسلوكا حياتيا اي في عبارة ، لقد ترك لنا ثروة روحية.
على ما يدل هذا الكلام؟
كل هذا يدل على ان الثروات مهما عظمت لا تحقق للسياسي مجدا ولا تجلب له شهرة ولا تدخله الى رحاب الخلود. لكن الأخلاق ممكن ان تكسب السياسي المجد والخلود في قلوب الأجيال والأمم. فاسمه (ص) صار يذكر خمس مرات عبر مسامع الدنيا كل يوم في حين نسيت ذاكرة التاريخ اسماء أغنياء عصره ورموز البورجوازية المكية!!!.
إن الأخلاق والآداب والروحانيات هي ما يكسب السياسي الخلود : ولهذا رأينا كيف ان رجالات السياسة عبر العصور كانوا يتهافتون على الشعراء والأدباء ويغدقون عليهم أموالا طائلة فقط من أجل انتزاع منهم قصيدة مدحية تروج لمكارم ولاخلاق مزعومة تمكنهم من دخول التاريخ !. كذلك كان ملوك آل ساسان والمناذرة (علاقة النعمان بن المنذر بالنابغة الذبياني في الجاهلية مثلا ..وهلم جرا خلال عصور الدولة العربية). فهل كان أولئك الحكام في حاجة الى ثروات مادية؟. كلا كانوا يمتلكون كل شيء إلا أنهم فقراء إلى “الأدب “اي الى الأخلاق…الى شيء ما روحاني يعلي مكانتهم ويكسبهم مصداقية ما ويخلد ذكرهم. ما هو ذلك الشيء ؟ إنه حب الشعوب او الجماهير…
وحي نلتفت، في إيامنا هذه، الى بعض النماذج السياسية ونرى كيف يتقاتلون من اجل المناصب السياسية، ويدافعون عن الوجه الوقح للسياسة، أي الوجه المادي، نشعر بخيبة أمل كبيرة، ولم يبق لنا ، كعزاء، سوى أن نتذكر رموز ماضينا الأماجد وتراثنا المجيد. بدءا بشخصة النبي( ص) وانتهاء بكل تلك النماذج النظيفة اللامعة في سماء التاريخ السياسي الإنساني “المظلم”.
هذه الفئة من السياسيين الذين يتخذون الدين قنطرة لبلوغ الدنيا ويجعلون السلطة معبرا إلى الثراء الفاحش تدل على أن السياسة صارت بلا أخلاق.
لقد فهم أولئك السياسيون أن السياسة مكر ودهاء، وتقرب من ذوي القرار ، ومجال لتوسيع دائرة النفوذ و ألة تمكنهم من فتح الأبواب المستعصية وتغيير الوضعيات الطبقية . الممارسة السياسة، من منظورهم، هي نوع من الإجابة عن سؤال: كيف يمكن للسياسي أن يصير غنيا في أربع سنوات. .او أقل؟ او كيف يتمكن من خداع الملايين بخطبة وكيف يصير بهلوانيا يقفز على الحبال، و ساحرا ماكرا يجعل الحق باطلا والباطل حقا.؟!
هذه حال الكثير من سياسيينا في وطننا العربي..
السياسة هي فن الخداع بامتياز سواء بارتداء قناع الدين او القبيلة او العرق ..المهم هو ان تنجح في خداع الجماهير وتصير غنيا في وقت سريع!
ولا غرابة أن تنتشر في المعجم السياسي الخاص بالسياسيين الجدد كلمات من قبيل “المعاش”..و”البيليكي”.ونراهم يزبدون ويرغون في المنابر جاحظي الأعين، يدافعون باستماتة عن المناصب و المال في وقت تتضور فيه الأغلبية الساحقة من أبناء وطنهم جوعا وتلتحف العراء.
ما أحوجنا إلى شخصة سياسية من طينة محمد( ص)
الذي قال عنه مؤلف “قصة الحضارة” المفكر والمؤرخ الأمريكي الشهير ويل ديورانت:إذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من اثر في الناس قلنا: إن محمدا أعظم عظماء التاريخ”. اجل إنه عظيم لا لأنه سياسي بورجوازي وإنما لأنه رجل مبادئ وعدل وأخلاق. وفي عبارة: إنه على خلق عظيم.