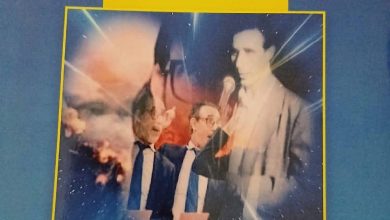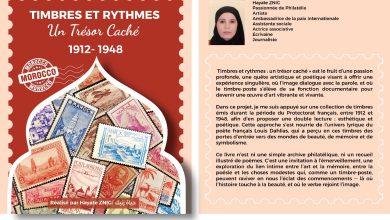فن وثقافة
حوار مع الناقد د. محمد الولي

حاوره صخر المهيف.
نستضيف في هذا الحوار الدكتور محمد الولي، وهو من مواليد 4 ماي 1949 بمدينة الناضور الواقعة في شمال شرق المملكة المغربية على البحر الأبيض المتوسط.نال شهادة الباكالوريا- شعبة الآداب العصرية- بمدينة الحسيمة سنة 1970 ثم التحق بكلية الآداب سيدي محمد بن عبد الله ومنها تخرج بوصوله على الإجازة في الأدب العربي سنة 1974، ولم تتوقف مسيرته العلمية عند هذا الحد، فقد حصل على شهادة الد راسات المعلقة من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1980 ثم دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في متم سنة 1986، ليختتم مسيرته العلمية بحوصوله على شهادة الدكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2000 بأطروحته” الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية” تحت إشراف الدكتور أحمد الطريق.
وقد اشتغل أستاذا للأدب في السلك الثانوي منذ العام 1975 إلى 1981 حين التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة مولاي إسماعيل بمناسبة سنة 1982 قبل أن ينتقل إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سنة 1994 وظل بها حتى بلغ سن التقاعد ليتفرغ كليا للتأليف والترجمة.
يعتبر الدكتور محمد الولي أحد أبرز الأسماء المشتغلة بحقل الدراسات البلاغية بالمغرب والعالم العربي من خلال صياغة أسس خطابية وشعرية جديدة مُحلِّقا بجناحَيْ البلاغة: الخطابة والشعر، ومن إسهاماته في هذا المجال كتاب: ” فضاءالاستعارة وتشكلاتها: في الشعر والخطابة والعلم والفلسفة، والتاريخ والسياسة” الصادر عن دار فالية سنة 2020 وكتاب:” الخطابة والحجاج بين أفلاطون وأرسطو وليبرمان” وله أيضا ترجمات مهمة في الحقل البلاغي ك”الشكلانية الروسية لدكتور إيرليخ سنة 2000 و “الكلام السامي: نظرية في الشعر” لجان كوهن 2013 ثم كتاب” الاستعارة الحية لبول ريكور عام 2016بالإضافة إلى اشتغاله بترجمة مشتركة لكتاب” بنية اللغة الشعرية” لجان كوهن بالاشتراك مع الدكتور محمد العمري 1986 ومؤلف” قضايا الشعرية” لرومان جاكوبسون مع مبارك حنون سنة1987 وكتاب “البنيات اللسانية في الشعر” لصمويل ليفن بالاشتراك مع خالد التوزاني 1989 و”الشعرية العربية لجمال بن الشيخ” بالاشتراك مع مبارك حنون ومحمد أوراغ 1996، و”البلاغة: المدخل لدراسة الصور البيانيّة” لفرانسوا مورو بمعيّة عائشة جرير، الطبعة الثانية صدرت سنة 2003.هذا بالإضافة إلى عضويته لهيئة تحرير عدد من المجلات المُحكمة، منها مجلة علامات، الذائعة الصيت في مجالها.
س 1: يعرفك المهتمون بحقل الدراسات الأكاديمية الأدبية المغربية والعربية بمشروعك البلاغي والخطابي، ماهو الدافع إلى هذا الاختيار؟
ج: كما تعرف هويتي هي التدريس، بدأت مدرساً في الثانوي وأمضيت الجزء الأكبر من حياتي المهنية أستاذاً في الجامعة بتخصص محدد هو البلاغة والشعرية وما يرافقهما من قبيل ترجمات أمهات البلاغة الغربية، من قبيل المساهمة في ترجمة بنية اللغة الشعرية لجان كوهن، والكلام السامي لنفس المؤلف، وقضايا الشعرية لرومان جاكبسون، والبنيات اللسانية في الشعر لصمويل روبير ليفن، والشعرية العربية لجمال الدين بن الشيخ الخ. وساهمت في الـتأليف بعدة كتب منها الصورة الصورية في الخطاب البلاغي والنقدي، والاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، وفضاءات الاستعارة، والخطابة والحجاج إلخ. كل هذه الأعمال تتسيّج ضمن التخصّصين المعروفين الشعرية والخطابة أوالحجاج، بطبيعة الحال كل هذه الأعمال هي دعامات أساس لما كنت ألقيه من محاضرات في الجامعات المغربية، في فاس ومكناس ومراكش والرباط، أنا في الأصل مدرس لهذا جاءت كل هذه الأعمال تأثيثا لمحاضراتي، القسم هو مختبري الذي أجرب فيه الكثير من العتاد الذي أشتغل به، وحيث أختبر ما أستورده من عتاد من القديم أو من الحديث، القسم هو مكان اختبار الأفكار وعرضها على المحك أمام الطلبة، في كل الأسلاك: الليسانس والماجستير والدكتوراه، إنني أنتمي إلى تلك الفئة من المدرسين الذين يربون فضيلة الاجتهاد في نفوس الطلبة، بمعنى فهم الماضي وهضمه وإعادة بنائه وتليينه البيداغوجي، هذا النزوع لا ينفك عن المهمات التي يتكفل بها المدرس، إنه رسول الأفكار، بل هو ساعي البريد، إنه ناقلة بمعنى آخر. هذه العملية ترفق عندي بمحاولات الفحص النقدي للأفكار والمواد المدروسة، إن الأفكار كلها قابلة لهذه المعالجات النقدية، في هذا السياق أنجزت ترجمات عديدة تصب في هذا البحر التجديدي في الشعرية والبلاغة والحجاج.إلا أن هناك سياقا ثانيا كنت أشتغل فيه ألا وهو المساهمة في هيئة تحرير عدة مجلات مغربية على رأسها مجلة دراسات أدبية ولسانية ومجلة علامات ثم مجلة والبلاغة وتحليل الخطاب، ذلك هو مختبري الثاني الذي كنت أنشط فيه مع باحثين آخرين، وللحقيقة والإنصاف، فإن السنوات التي قضيتها بصفتي عضوا في هيئة التحرير في علامات وتتعدى الآن ربع قرن، كانت نتيجتها أن هذه المجلة نشرَت حولها مناخاً تجديدياً في السميائيات والبلاغيات والتأويليات في كل العالم العربي، هذه المجلات كانت في جملتها ذات نفس وتطلع تجديدين، وللحقيقة مرة أخرى فالهمّ التجديديّ لم يكن هو الأساس، بل الأهم كان بعث روح من الجدية والصرامة في العمل الذي كنا نقوم به، ينبغي هنا تقديم التوضيح التالي: فإذا كنا في القسم مقيدين بعدة اعتبارات كالمقرر وسنة التدريس والامتحان والتنسيق مع أساتذة المادة أو التخصص، فإننا كنا نجد في هذه المجلات تلك الحرية التي نعدمها في الأقسام، في القسم تقوم بعملك الذي يلزمك القانون بالقيام به، أما في المجلات فأنت حر في أن تكتب وتطرح ما تراه مناسبا من الناحية العلمية، فلا أحد يلزمك بألا تكتب شيئاً.
س 2 : هل استنفدت البلاغة العربية الكلاسيكية ذاتها بعد نهاية العصر الذهبي للحضارة العربية الإسلامية؟
ج: في الحقيقة البلاغة العربية أنجزت مهمات تاريخية مهمة في الدائرة الحضارية الإسلامية العربية، أولا لقد تمكنت من حصر موضوعها بدقة متناهية كما تمكن اللغويون العرب من تدوين الإرث الشعري وتحقيقه وشرحه وتصنيفه وترتيبه، بعدذلك جاء البلاغيون العرب وعينوا ورتبوا مجموع المقومات البلاغية باعتبارها كيانات نصية، إنها بلاغية شكل النص أو جماليته، أي مجموع الملامح اللغوية الكفيلة بإحداث تأثير إحساس جمالي في المتلقي، أكاد أقول: إن مجمل الملامح التي دونتها البلاغة العربية تندرج في إطار المقومات الجمالية المؤثرة، من قبيل هذه المقومات نجد التشبيه والاستعارة والكناية والتوازي والجناس والتكرار والتقديم والتأخير والمجاز العقلي والتمثيل والرمز إلخ، بل الأهم والأخطر من كل هذا هو إقامتهم مراتب ودرجات الفوز الجمالي، لا نندهش ونحن نرى كيف جعلوا الاستعارة سيدة الملامح الشعرية، كانت البلاغة تكمل ما ينجزه علماء العروض والقافية ونقاد الأدب وعلماء الضرائر الشعرية والفلاسفة، بالإضافة إلى شراح شعرية أرسطو وخطابته، فإذا كان العروض الخليلي وعلماء الضرورة مثل أبي سعيد السيرافي تلميذ سيبويه ونقاد الأدب مثل الجاحظ قد لوّنوا البلاغة العربية باللون المحلي الأصيل، فإن شراح أرسطو مثل الفارابي وابن سينا وابن رشد قد خلعوا على البلاغة العربية الألوان الوافدة… كل هذه التخصصات تصب في بحر ما يمكن أن ندعوه نظرية الشعر أو البلاغة العامة، لقد أنجزت هذه التخصصات مشاريع هامة جداً تعتبر أساس كل المحاولات التجديدية في القرن العشرين، لا يمكن أن نقول بأن تلك المعرفة البلاغة والشعرية قد ماتت وأصبحت من المتلاشيات، ورغم هذا الإقرار وجب القول إن تلك المعرفة لم تعد كافية لإلقاء الضوء على الأصقاع اللغزية في الإنتاج الأدبي، لأن تلك المعرفة البلاغية قد تم بناؤها ضمن سياق له همومه التي لم تعد هومنا، إن ذلك الهمّ الذي رضعت البلاغة العربية حليبه لم يعد همَّنا نحن الذين تعلمنا على الشكلانية الروسية والبنيوية الفرنسية وجمالية التلقي الألمانية ومدرسة تَارْتُو همًّا ماضويا، أو لم يعد يحتل الحيز نفسه الذي كان يحتله، ولكي نعطي مثالا واحدا للتوضيح فإن المجاز العقلي في البلاغةالعربية نشأ في بيئة دينية وإن شئت فقل كلامية، هذه لم تعد همومنا نحن الذين نعيش في كوكب معولم، استبدل حدود الإمبراطوريات والدول بعالم أصبح كله مجرد قرية صغيرة، هكذا أصبحنا في البلاغة الحديثة منشغلين بالملامح العامة لهذا الذي نسميه شعرا أو بلاغة. لم يعد شعار الجاحظ “فضيلة البلاغة مقصورة على العرب” متمتعا بأي بريق، بل ربما رأينا فيه اليوم شعاراً عنصرياً، تماما كما أن شعار أرسطو بأن صفة “السداد العقلي لا يتمتع به إلا المواطن الأثيني” وما عداه مجرد بربريّ لا تصدر عنه ممارسات لوغوسية سديدة، لقد انتهت هذه الأساطير في البلاغة الحديثة، ولكن رغم كل ذلك فإن المنجز التقليدي الموروث يوفر مدونة مهمة صالحة كمادة لبناء صروح جديدة، بعبارة أخرى لا يمكن أن نحنط القديم ونقول إنه يقدم كل الأجوبة على الأسئلة التي يطرحها النص الأدبي، إن الزعم بأن البلاغة القديمة عربية وغربية تقدم كل الأجوبة على أسئلة الخطابات الشعرية والإقناعيّة إنما هي دعوى إيديولوجية تقصد إلى تكليس المعرفة في صيغة ماضية جاهزة وتمنع عن الاجتهاد وطرح الأسئلة الجديدة المتعلقة بكل أجناس الخطاب.
س3: ما الجدوى من الخطابة في الراهن العربي؟
ج: الخطابة بمعناها العام هي كل كلام يلقيه المرء للتأثير في الآخر، ومحاولات تغيير سلوكه أو تثبيته، إن خطاباً عائلياً وخطابَ المدرس في القسم والواعظ أو الخطيب في المسجد والنشرة الإخبارية والإرساليات الإشهارية وكاتب المقالات الصحفية ومحرر البيانات الحزبية بل وحكايات الجدات للأطفال والمرافع في المحكمة وخطاب المحلل النفسي أو الطبيب إلخ … كلها خطابة تسعى إلى تعديل الأفكار والسّلوك، بل إن عدة رسائل تبدو مصونة من هذا المسعى الخطابي الإقناعي، هي خطابية وأحيانا خطابية قوية، إن عبارة I Love you على سبيل المثال لا الحصر، قد تبدو للبعض عبارة بريئة من أي قصد حجاجي، والواقع أن حجاجيتها متوقدة بل يمكن أن نجد فيها استعطافا وتوسلا وأمرا إلخ… أغلب خطاباتنا هي خطابات حجاجيّة الغرض من وراءها هو التأثير في الآخرين، بل إن الخطابة تتجاوز التحققات اللفظية إلى الممارسات غير اللفظية، من قبيل الزي الذي لا يحمل دلالة فقط لكنه بالمقابل يبعث استجابة من جهتنا نحن المعنيين بذلك الزي وشكله.
س4: وماذا عن البلاغة بمعناها الشعري؟
ج: البلاغة بمعناها الشعري لا تخلو من القصد الحجاجي التأثيري، فقط البلاغة الشعرية هنا تشتغل بمواد رطبة ولينة، فتتخذ لها الممرات إلى العقل عبر التأثير في القلب، إنه الإقناع المستتر حسب عبارة Packard Vance فانس باكار في كتابه الذائع :Persuasion clandistine إن البلاغة الشعرية يمكن إدراجها ضمن المُقْنِعات المواربة.
س5: حاولت في مؤلفيك: فضاء الاستعارة وتشكلاتها: في الشعر والخطابة، والعلم والفلسفة، والتاريخ والسياسة الصادر عن دار فالية بالمغرب سنة 2020 والخطابة والحجاج بين أفلاطون وأرسطو وبيرلمان، أن تعمل على تجديد البلاغة العربية، بعد أن رصدت البلاغة الغربية في محطاتها الثلاث من أفلاطون مرورا بأرسطو وانتهاء بالفيلسوف شايم ليبرمان، بالاستناد إلى صياغة أسس خطابية وشعرية جديدة بخلخلة صروح البلاغة العربية التقليدية، هل يمكنك أن تحدثنا عن الأمر قليلا؟
ج: إن قراءتي للبلاغة العربية القديمة وللبلاغة أو الخطابة اليونانية هي محاولة لتجديد فهم القدماء، لا ينبغي أن نكتفي بترديد أفكارهم كما هي، إن هناك محاولةلفهم وتفسير بل وتأويل أخرى، إن نظرية الأدب قد حققت في العصور الحديثة خطوات جبارة في كشف الكثير من الجوانب المظلمة في الإبداع الشعري، إننا نستعين بهذه الثورات الشعرية والحجاجيّة والخطابية لفهم تراثنا، نحن لا نحاول تملك النظريات المعاصرة الوافدة فقط بل نستعين بها لفهم أفضل لتراثنا فنعيد صياغته على ضوء الإنجازات المعاصرة، وكأننا بهذه العمليات نُلحق ما كان منزويا في الدائرة الحضارية العربية الإسلامية بدائرة أوسع هي الدائرة العالمية، كأننا نجعل البلاغيين العرب يتحدثون لغة المعاصرين، وبهذه العملية نخرج التراث من قوقعته لنجعله يتحاور مع العالم حوار أنداد لا حوار أتباع وكأننا نحاول أيضا أن نجعل خصوصية هذا التراث ترتقي سلم العالمية، فنفتح في وجهه الحدود التي كانت تمنعه من العبور إليها، نحن نحاول إذن أن نفهم القدماء بشكل أفضل بما فعله الأسلاف، فالمعرفة العلمية تتمتع بخاصية طرح أسئلة جديدة لإدراك أجوبة جديدة، وما أن تتحول هذه الأجوبة إلى معرفة قارة فإنها تميل إلى الثبات، ذلك أن التحجر ومقاومة التغيير وتجديد الأسئلة، وأعني بذلك تحول المعرفة الدينامية الحية والثورية يقود إلى إيديولوجية متكلسة وتبريرية. هذا الفهم الجديد جزء من فهم الإنسان في العالم ويعتبر بالتالي تحفيزا لتغيير أحوال البركة الراكدة.
س6: كيف تقيّمون محاولات اقتحام البلاغة المغربية والعربية -بعد تجديدها- مجال الشعر والإشهار والسرد والدعاية السياسية؟
ج: لا شك أن هناك إنجازات مهمة تحققت في مجال السرديات والشعريات، إن مدارس الشكلانية والبنيوية وجمالية التلقي والنقد الثقافي والتحليل النفسي والتاريخي قد حققت تراكمات هامة جداً، إن الكثير من النصوص المؤسسة قد ترجمت إلى العربية وفي الكثير من الأحيان ترجمات ممتازة، إن نظريات سوسور وجاكبسون وتشومسكي ومارتيني وجورج مونان وجان كوهن وبول ريكور وجاكندوف وجورج لايكوف ومارك جونسون وريتشاردز وماكس بلاك ونيتشه وآخرين لم تعد غريبة عن الباحثين العرب، ثمة استيعاب ما هو مهم. نستطيع أن نعبر عن رضانا إزاء ما تحقق بصدد معرفة أمهات النصوص النقدية الغربية وكذلك بصدد التطبيقات في مجالي الشعر والسرد، وفي مجال الإشهار فلا أكتمك أن المنجز في هذا المجال أقل منه في الجنسين السابقين، وأعتقد أن مساهمات بنكراد بما نشره من كتب في الموضوع أو بما نشره من مقالات غيره في علامات إنجاز بالغ الأهمية، ولا أعتقد أن ما تحقق في مجال الدعاية السياسية يرقى إلى ما تحقق في الأجناس السابقة، والسبب يعود في كل حال إلى أن خطاب الدعاية السياسية وتحليله يتطلب قدرا كبيراً من الحرية، لا أعتقد أن الباحثين المغاربة والعرب يتمتعون به. وفي الحقيقة فمن الحق القول إننا ما نزال في مرحلة استيعاب التراث العربي وفهمه فهما جيدا وتأويله في ضوء النظريات المعاصرة، وتبعاً لذلك وفي السياق ذاته، أعتقد أننا استوعبنا الكثير من النظريات الحديثة وترجمناها وفي الكثير من الأحيان ترجمات جيدة، كما أننا طبقنا الكثير من النظريات الغربية على تراثنا، إن محاولاتي الشخصية في ما يتعلق بإدخال النظريات البلاغية إلى مجالات لم تكن تحلم بها في السابق مثل تلك المحاولات المتعلقة بتحليل لوحات للفنان البريطاني المجهول وتحليل الشعر الجداري في أمريكا اللاتينية وشعارات الثورة الطلابية ماي 1968، كلها محاولات لإخراج البلاغة من الممارسة الكتبيّة إلى الهواء الطلق، تلك محاولة لجعل البلاغة تنخرط في عمليات التحولات الاجتماعية.هناك أيضا محاولة للاهتمام بالأجناس الصغري كالشعارات السياسية والإشهاريات والأمثال، إن هذا يعزز محاولات إخراج البلاغة من الخرائب الكتبية إلى صهد الحياة السياسية التي تستعين بالأجناس الخطابية المصغرة كالشعارات السياسية والجداريات، طبعا محاولتي تمثلت في الإفصاح عن رسالة تقول إن الأدب الرسمي ليس هو وحده ما يستحق الاهتمام، بالنسبة إليّ أحاول التغلب على الفراغ السياسي الذي لا أتوفر عليه لممارسة حريتي، إن هذه المغامرات هي محاولة للتنفيس عن المكبوت السياسي، إنها أحلامي المتمردة، و في كل الأحوال فإنها محاولات تطبيقية لأن الأدوات المستخدمة كلها غربية، إن ابتكاراتنا تظل مشروطة بهذه الحدود، أي أن الابتكار العلمي لنظريات جديدة لا يبدو أن شيئا منها تحقق في عالمنا العربي.
س 7: ما هو أفق الترجمة في العالم العربي؟
ج. لا أشك أن العالم العربي يتوفر على مترجمين ممتازين، إن أسماء من قبيل محمد عصفور وجابر عصفور وشكري عياد وعبد الرحمن بدوي وحمادي صمود وعبد القادر لمهيري وعبد المجيد جحفة ومحمد غليم وحسن الطالب وذاكر عبد النبي ومحمد خطابي وخليل أحمد خليل وجورج طرابيشي ومحمد البكري وسعيد بنكراد ومحمد العمري وابراهيم الخطيب وعبد الحي أزرقان قد أغنت الساحة البلاغية العربية، إلا أن ثمة ملاحظتين تفرضان نفسيهما في سياقنا:الأولى تتعلق بواقع الترجمة في العالم العربي الذي تغلب عليه العصامية والمبادرات الفردية، إذ ليست هناك مشاريع ومخططات لترجمة أمهات الأعمال النظرية والأدبيةالعالمية، سواء كان ذلك في مستوى وزارات البحث العلمي وفى مستويات البحث الجامعي أو في مستوى دور النشر المختصة، فالوضع الغالب هو انعدام أبسط الأعمال التنسيقية في عالمنا العربي، كل هذا يشعرنا بأن الانتقال من بلد عربي إلى آخر يشعرنا بأن هناك تغييرا للغات المصطلحية إلى حد أن الانتقال من مدينة إلى أخرى تشعرنا بهذا التفاوت المصطلحي وهذا مثير جدا، في هذا المناخ تهيمن الأنانية وجميع صنوف الانتهازية، وعلى الرغم من كثرة الترجمات الجيّدة التي هي نتاج المبادرات الفردية، ما تزال هناك أعمال كثيرة مترجمة ترجمات سيئة، هذا إذا تجاهلنا بعض العادات السيئة وانعدام الذوق والوازع الأخلاقي المتمثل في السرقات المواربة وغير المواربة، طبعا هذا يدل على فوضى ما تعيشه الترجمة عندنا بوجود ترجمات كثيرة سيئة كما أسلفت، إن مترجمين كبيرين من عيار محيي الدين صبحي وحسام الخطيب تشكو ترجمتهما لكتاب النقد الأدبي تاريخ موجز لوليام ك. ويمزات وكلينبث بروكس من عاهة الاستغلاق في كثير من فقراته، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كتاب جان كوهن الذي ترجمه أحمد درويش. فكأن الرجل نشر المسودة الأولى للترجمة، بل إن كتابا من عيار الاستشراق لإدوار سعيد لم يحظ -بعد الترجمة الرابعة- بترجمة تحظى بالقبول التّام، لا أعرف بين الترجمات الفرنسية أو الإسبانية إلا ترجمة واحدة لكتاب الاستشراق وكلتاهما موضع تنويه، ولتكن هذه مناسبة لطرح مسألة تهمني، وأعني بها الترجمات المشتركة، أعتقد واعتماداً على تجاربي الشخصية، أن الترجمات المشتركة هي الأقل عرضة للزلل عندنا، إن الرقابة تكون مضاعفة والحرص على التصفية يكون أقوى، بل إنني أفضل الترجمات المشتركة على الترجمات الفردية التي يوقعها مراجع، إن الترجمة غابة كثيفة وولوجها الانفرادي يجعل المرء عرضة لكل أنواع المخاطر، والدخول إليها مع الرفقة الجيدة يجعل المزالق أقل تأثيراً، أعظم الكتب التي ترجمتها هي تلك التي أنجزتها ضمن مجموعة . لذلك جاءت أغلب ترجماتي في شكل ترجمات جماعية، المراجِع في العالم العربي لا يلبي غالبا حاجة الترجمة الجماعية، إذ كثيرا ما اكتفى بالتوقيع دون المراجعة، وهذه معضلة، علاوة على أن وضع المراجع وضع غامض في الترجمات العربية، واعتمادا على تجاربي الشخصية، كثيراً ما أثبت اسم مراجع الترجمة على الغلاف دون أن يراجع شيئاً، إن الترجمات المشتركة تستفيد من خبرتين علميتين كما تستفيد من القدرات التأويلية للمترجمين. المطلوب في العالم العربي وضع مخططات لترجمة أمهات التراث الانساني، مخططات وانتقاءات تقوم على اعتبارات الأهمية بالنسبة إلى الحاجات الوطنية، طبعا لا ينبغي لهذا أن يلغي المبادرات الفردية التي أعتبرها إحدى دعامات النهوض الثقافي والاكتشافات الأساس التي تغيب عن اختيارات الدولة، وتبعا لهذا يجب تنظيم لجان الفحص والمراجعة والتزكية، وينبغي سن قوانين تحدد أجر المترجم، بل وتبني المعيار الدولي في هذه الدائرة. ينبغي حماية المترجم وحقوقه وضبط عمليات الاختلاس واعتماد التقنيات الالكترونية لضبط الغش والتدليس، فكم مرة سمعنا بأطروحات مسروقة بكاملها،هذه الأمور ينبغي ضبطها.